
لم يكن هناك مكان فى العالم يمكن للعسكر والفلاسفة أن يلتقوا فيه إلا فى الإسكندرية التى أسسها الأوائل من البطالمة ورثة الإسكندر
يشغلنى كثيرا الاهتمام بحل العقدة التاريخية الخاصة بكيف يمكن لمجتمع استقر فيه الدين داخل الأعماق الفكرية والسلوك اليومى، أن يخرج من هذه البوتقة وينتقل إلى حيث يوجد العالم الحديث والمتقدم؟ فى مقال آخر لاحظت أنه فى نهاية المرحلة الفرعونية من التاريخ المصرى تعجب كهنة الديانة الأوزيرية من سلوك الهلينيين (أهل اليونان الآن) الذين وفدوا إلى مصر ينهلون من علمها القديم وفنونها المبهرة. ولخص كاهن قضيته مع الوافدين الجدد بالقول «إنهم كالأطفال يسألون أسئلة كثيرة"؟! كانت الحضارة المصرية قد كفت عن التساؤل حول الحياة وما يجرى فيها فى مرحلة باتت فيها الدنيا أكثر تعقيدا مما كان عليه الحال قبل ثلاثة آلاف عام عندما مرت مصر بعهود قوة انتهت إلى ضعف وتهافت. كان الجيش المصرى قد خاض آخر معاركه فى عام ١٨٦ قبل الميلاد بينما بدأت تهل على الإنسانية حضارة أخرى كان نجمها العسكرى الساطع الإسكندر الأكبر؛ بينما كانت نجومها فى الفلسفة والفكر من سقراط إلى أفلاطون إلى أرسطو إلى أبيقور، وعشرات غيرهم يطرحون على الكون أسئلة لم يجرى طرحها من قبل. وربما لم يكن هناك مكان فى العالم يمكن للعسكر والفلاسفة أن يلتقوا فيه إلا فى الإسكندرية التى أسسها الأوائل من البطالمة ورثة الإسكندر؛ ولكن سيرتها التاريخية راحت مع المكتبة والبحث العلمى. ذكرنى بهذه التطورات التاريخية مقال د. جمال عبد الجواد «نقص الفضول العلمى» والذى اختار فيها لحظة تاريخية أخرى ألمت بعد ألفين من الأعوام حينما قارن بين الحالة الأوروبية والحالة المصرية فى لحظة الحملة الفرنسية، وما تبعها من حملات إنجليزية على مصر. كان الفضول وحب الاستكشاف وظهور العلم فى فهم الحياة واستيعاب الكون هو الفارق مع واقع آخر قام على الثوابت والنصوص والعيش على ما سار عليه آباءنا وأجدادنا دون اعتبار لما ألم بالدنيا من متغيرات لم يعد فيها الزمان كما كان، ولا كذلك المكان، وبتعبيرات أخرى لا التاريخ ولا الجغرافيا ثبتا أمام التحديات العلمية وتجاوزات السرعة، والثورة فى الثروة، والاختراق فيما وراء العالم من فضائيات خارج الكرة الأرضية وداخلها.

قرنان انقضيا منذ ذهب نابليون، وخلالهما جرت محاولات للتجديد فى التفكير والتغيير فى الواقع، وبينما كان ممكنا استعارة تكنولوجيات الحضارة الغربية من سكك حديدية إلى التلغراف وحتى الكومبيوتر والذكاء الاصطناعي؛ ولكن كان الفضول العلمى والاستكشاف والشغف بالمجهول مستعصيا على التفكير. محاولات على عبد الرازق وطه حسين وحسين فوزى وسلامة موسى وغيرهم سرعان ما شحبت، وبقى معنا أفكار حسن البنا وسيد قطب، وحتى بعد رفضهما ظل التفكير التأمرى والعداء للفضول والاستكشاف ذائعا ومؤثرا فى الفكر المصرى الفلسفى والسياسى. محاولات عبد الناصر فى القومية العربية، والسادات فى الوطنية المصرية، ومبارك فى اليقظة الاقتصادية خاصة فى أعوامه الأخيرة؛ تكسرت كلها على موازين القوى فى عالم المعرفة والفضول والتساؤل وطرح الأسئلة الأولية. الرئيس السيسى ربما كان بين الحكام أول من طرح وبشجاعة «ضرورة تجديد الفكر الدينى» وكان ذلك داخل الأزهر قبل سنوات، واستمر فى هذه الدعوة حتى الآن. كان ذلك قبل التطورات الهامة التى جرت فى الأزهر مع توقيع وثيقة «الأخوة الإنسانية» بالتعاون مع بابا الفاتيكان فى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وقبل الثورة الفكرية والتجديدية الجارية الآن فى المملكة العربية السعودية التى قيل فيها صراحة أنه لو عاد محمد بن عبد الوهاب لرفض ما جرى عليه الاستقرار من أقوال حاجبة للعقل، ومعها فى العادة الضمير.
الشائع داخل العربى الآن هو البحث فى الكيفية التى يتم بها تجديد الفكر الدينى خاصة بعد التطورات التى جرت خلال العقود الأخيرة، وفيها جرى الانتقال من «الأصولية الدينية» المتطرفة إلى درجات مختلفة من العنف أصابت ما سمى «العدو القريب» فى بلاد العالم الإسلامى، وما سمى «العدو البعيد» فى بقية بلاد الدنيا. لم يعد فى الحقيقة هناك ما كان يسمى دار الإسلام ودار الحرب، وأصبح كل العالم ساحة معركة دامية. الموضوع ولا شك شائك ومتشعب، ولكن جانبا هاما منه ارتبط بنوعية الفكر الدينى الذى يدفع إنسانا لقتل أخيه الإنسان وحرقه والتمثيل بجسده، أو حتى يقوم بالعمليات الانتحارية التى يضيع فيها المنتحر مع ضحاياه. الجانب الأمنى هنا ليس القضية، ولكن الجانب الفكرى ذهب بتركيز كبير على المؤسسات الدينية وعما إذا كانت قد قامت بواجبها أم لا فى شرح صحيح الدين المعتدل والوسطى. الجهد الذى قامت به مؤسسات الأزهر والأوقاف ومثيلاتها فى دول عربية ما زالت تقوم به فى حدود ما هو معلوم من حدود قامت واستقرت لأكثر من ألف عام. ولكن ما يهم فى الموضوع هو أن التجديد لابد وأن يكون فى الفكر مدنيا كان أو دينيا، ليس فقط لمقاومة الإرهاب، أو مواجهة ما هو متطرف وعنصرى ولا أخلاقى، وإنما لإعلاء قدرة الإنسان على التفكير فى أمور الحياة المتغيرة، والتعامل معه لتحقيق «التقدم» الذى هو بدوره قيمة كبيرة وتستحق التفكير والعمل من أجلها. «تجديد الفكر الدينى» لا يكون فقط من خلال التعامل مع الأصول الدينية، وإنما أيضا بتقديم فكر مدنى لا يكتفى فقط بنقد الفكر الدينى، أو هجاء الشعوذة الشعبية أو السلفية، أو النظر فى العادات الأهلية متخلفة، فيها بعض الفائدة عندما تجرى فى إطارات مقارنه مع عالم متقدم. مثل ذلك يمكن تقدير الشجاعة فيه، ولكنها من ناحية أخرى لا تؤدى إلى تغيير المجتمع مكتفية بتصنيفه إلى شرائح وطبقات راقية ووضيعة، متقدمة ومتخلفة، وهكذا تقسيمات.
ومن الملاحظة والتجربة لما يحدث فى بلادنا فإنه لم توجد معركة من نوعية «البوركينى والبيكينى» إلا وصبت فى قناة التقسيم المجتمعى ولصالح الجماعات الأكثر تطرفا. وبالملاحظة والتجربة فى بلاد العالم التى سبقتنا، ورغم السبق فإنه لا زال فيها التفكير التآمرى والكثير من الشعوذة الدينية، فإن بداية التغيير لم تأتى فقط من «الإصلاح الدينى» وإنما جاءت من «العلم» و«العلوم» و«المعرفة». ولو أن الكتاب والمفكرين المهتمين بهذه القضية صرفوا جزءا هاما من وقتهم، ومساحات أكبر من كتابتهم، إلى التفكير العلمى والبناء المنطقى وأساليب البحث فى الأمور، والعلاقة بين المقدمات والنتائج، والكيفية التى تطورت بها الدنيا على مدى العشرة آلاف عام الماضية التى بدأ عندها التاريخ الإنسانى شاملا أديانا وأفكارا وتقاليد وأخلاقيات كانت ضرورية لتحقيق سلام الإنسان مع ذاته، وتعاونه مع أخيه الإنسان. التاريخ هكذا ليس مجرد تسجيل صعود وهبوط الأمم، وانتصارات الإسكندر الأكبر وبطولات خالد بن الوليد وفتح الأندلس وغزوات نابليون وهتلر، وإنما هى كيف جاء الإنسان من كهفه، ورحلته من جمع الثمار حتى الوصول إلى القمر. هذا التطور منذ وقوف الإنسان على قدميه معلنا خروجه من المملكة الحيوانية وحتى بات يقترب من مركبات تسير بسرعة الضوء، وبعد أن كان يعلن «العجز» قبل سن الثلاثين وحتى بات شابا من هو فى الثمانين، هى قصة تستحق أن تروى علميا وتكنولوجيا وفلسفيا أيضا.
وبقدر ما يحكى تاريخ البشرية قصتها مع التطور والرفعة، فإن التاريخ وحده فيه أبلغ القصص ليس فقط بإقرار الوحدانية والحساب بعد الموت، وإنما فى التعامل مع الجسد الإنسانى وقوانين الجاذبية أيضا. وظيفة التاريخ للإنسان والشعوب أنه مخزن التجربة ليس خطأ أو صوابا، وإنما عما إذا كان مفيدا أو غير مفيد. وضع أحكام قيمية، وفى كثير من الأحيان ليبرالية ومستمدة من تجربة القرنين الأخيرين من التاريخ البشرى غير عادلة لوظيفة التاريخ الذى إذا ما أثقلناها بمعايير أخلاقية أو سياسية أو اجتماعية لما بات التاريخ تاريخا كان فيها الإنسان أسيرا لظروف العصر والزمن والتطور. التاريخ أيضا ليس هو ما فات، وإنما ما هو قادم أيضا طالما أن العلاقة واقعة مع الزمن الذى فات، والآخر الذى سوف يأتى. هنا مربط الفرس فى تجديد الفكر المدنى أن يكون نافعا فى بناء الدولة الحديثة والمعاصرة؛ وبصراحة يكون أكثر تحملا للمسئولية عن تقدم مجتمعنا.
لمطالعة موقع ديالوج.. عبر الرابط التالي:




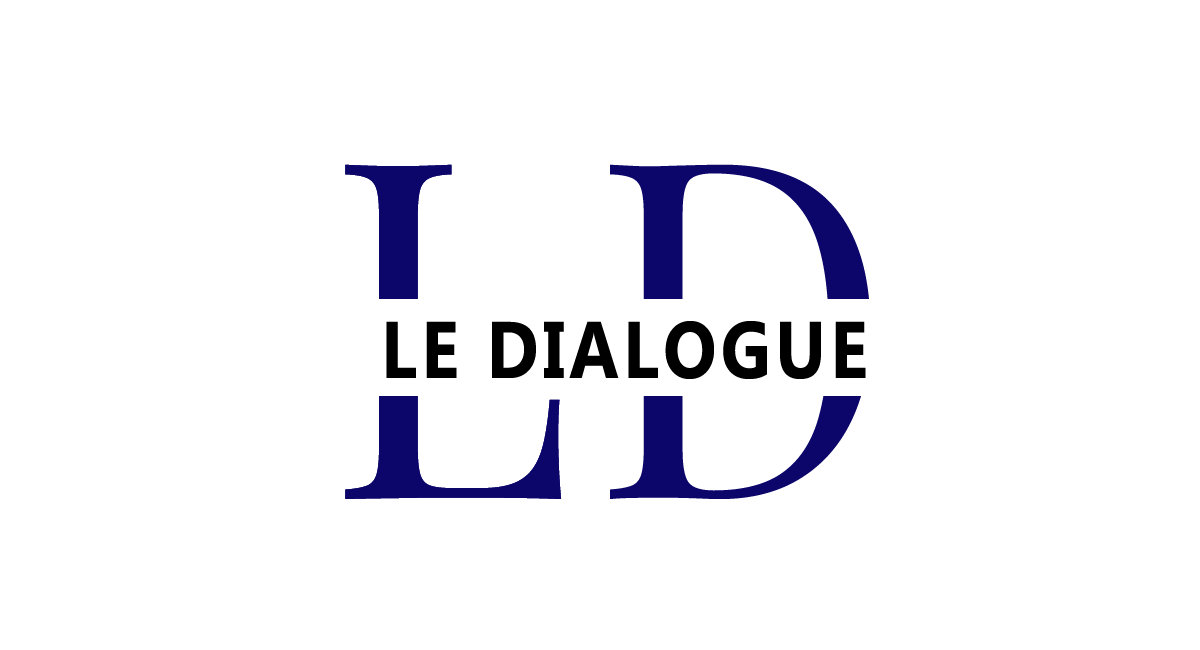 بالعربي
بالعربي
